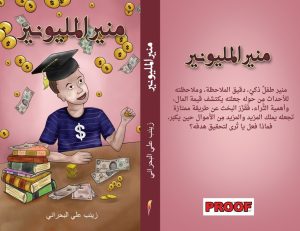هل نستحق حُرية التعبير؟
بقلم: زينب علي البحراني
يُعلن الإنسان عن رغبته في التعبير عن ذاته بصرخة احتجاجه الأولى على مواجهة عالمه الجديد بعد خروجه من رحم والدته، ومع ازدياد احتياجاته الجسدية والنفسية والعاطفية تزداد تلك الرغبة وتتطور أشكالها، تبدأ واضِحة ومُباشِرة في مُطالبتها بالغذاء والدفء والحماية، ثم تجد نفسها مُضطرّة لارتداء أقنِعة مُلائمة لتمرير رغباتها ومطالبها في صورة يعتبرها المُجتمع “مقبولة” بعد تجاوزه مرحلة الطفولة، أو بوصفٍ أقرب إلى الدقة: بعد تجاوزه مرحلة “البرمجة” و”التدجين” التي تجعل منه فردًا صالحًا للاتساق مع المنظومة المُجتمعية دون إرباك كبير لأنساقها المُتعارف عليها وأنماطها المُعتادة، لكن “الإشباع الغريزي” وحده لا يكفي، هذا إن وُجد كاملاً إلى حدٍ مُشبعٍ حقا، أما الإشباع النفسي والعاطفي فيندر اكتماله، لذا تبقى حاجة داخليّة مُلحة في وجدان الإنسان للتعبير عن المشاعر والانفعالات سواءً كان هذا التعبير حقيقيًا صادقًا، يُظهر ما يُبطنه دون مُخاتلة، أو كان شبيهًا بـ”جعجعة” تحاول لفت اهتمام الآخرين إلى قضايا ظاهريَّة بينما تخفي بين طياتها استياءً من أوجاع سريّة أخرى، إننا كبشر ” نحترق من أجل أن تكون لنا آراء، ويكون لنا حق تغييرها” كما يقول الفيلسوف والأديب الألماني فريدرك نيتشه، لذا تكون الحاجة لحُرية التعبير أقرب إلى الحاجة للتنفس، وربما يمكننا أن نطلق عليها مُسمى “تنفس الروح”، ودون تلك الفسحة من الأكسجين متمثلة بـ”الحُرية” تبدأ مرحلة الاختناق، ثد تأتي “غريزة البقاء” لتؤدي دورها مشعلة نيران الثورة بعد أن تتجاوز قدرة الكائن البشري على التحمل مداها.
لطالما كان الناس ومازالوا في عالمنا الناطق باللغة العربية يُطالبون بـ”حُرية التعبير”، لكن السؤال الذي بدأ يطرح نفسه بإلحاح بعد أن فتحت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني أبوابها على مصاريعها لاحتواء كل رأي وكل فكرة ومُعتقد: “هل نحنُ مُستحقون حقًا حرية التعبير؟ هل نحن بحجم تلك المسؤولية، أم أنها سلاحٌ مازلنا غير مؤهلين لإمساكه بأيدينا؟”.. ويكفي أن نتابع مستوى الحوار الدامي بين سُكان تلك البيئة الافتراضية لنكتشف الجواب، وإذا كُنا واقعيين وصادقين مع ذواتنا فسنعترف به لأنفسنا بشفافية رغم تنهيدة الأسى والأسف، أما إذا كُنا ممن يعيشون في كهف “الإنكار” الأزلي للحقيقة فسنُعاند ونُكابر ونشجب ونرفض كالمُعتاد، وفي كلتا الحالين تبقى الحقيقة واحدة.
حُرية التعبير للفرد تتطلب – بالمُقابل- مُجتمعًا انسانيًا واعيًا بأهمية تلك الحُرية وبقيمتها، مُستعدًا للإنصات، والتفاهُم، والإقناع، والاقتناع بهدوء وموضوعيَّة تخلو من آثار غريزة العُنف، بينما مجتمعاتنا – بمعظمها وليس جميعها- مازال الفرد فيها يعيش حربًا داخلية خفية مع ذاته ومع الآخر، فهو يريد أن يكون على حق حتى في دفاعه عن الباطل، ويُريد أن ينتصر حتى لو كانت قضيته مهزومة من كل الجهات، ويُريد أن يُطلق سبابه وشتائمه وكل قاموس ألفاظه البذيئة دون حساب. وبدلاً من أن تكون حُرية التعبير جسرًا وديًا للتواصل مع الآخر وتبادل الأفكار والخبرات معه؛ تغدو خطًا شائكًا مزروعًا بالألغام والقنابل العشوائية! ولعل من أشجع الآراء الجريئة التي سمعتها وقرأتها بهذا الصدد كان رأي الفيلسوف والروائي الإيطالي المتميز أمبرتو إيكو حين قال: “إن أدوات مثل “تويتر” و”فيسبوك” تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضررٍ للمُجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورًا. أما الآن؛ فإن لهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل.. إنه غزو البلهاء!”.
استحقاقنا حُرية التعبير يجب أن يكون محدودًا بالحدود التي لا يتجاوزها إلى “حُرية التخريب”، لكننا مازلنا في المرحلة التي تتحكم بها التقلبات الهرمونية لـ”سيكولوجية الجماهير”، فما أن ينطق شخص بكلمة أو يكتبها حتى يُشمر أي عدو مجهول عن مخالب عداوته، ويقلب معاني الكلمات رأسًا على عقب، ويحشر بين فكّيها أطنانًا من سوء الظنون زاعمًا أنها تستهدف الإساءة لشخصٍ أو جماعة كي يستعدي الآخرين ضده في سبيل إشباع أحقاده الشخصية الدفينة، وسرعان ما تتبعه جحافل المشاركين في هذا الأذى راكبين موجة التسلية بتلك الثرثرة دون وعي بمدى الخطر الذي تؤدي إليه، ودون إدراك إلى أنهم بسلاح “حُرية التعبير” الذي يملكونه؛ يُحاربون “حُرية تعبير” شخصٍ آخر لا ذنب له إلا مُمارسة ما يعتبرونه حقا خالصًا لهم وحدهم!
*تاريخ النشر:
السبت 13 يناير 2018م- النسخة الورقية من جريدة “جود نيوز” الكندية.